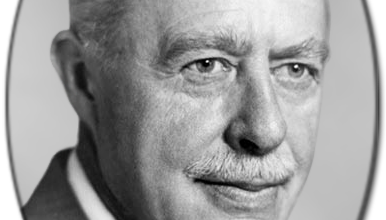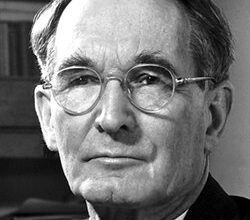أبو حنيفة النعمان: ومضات فذة من عبقريته وذكائه
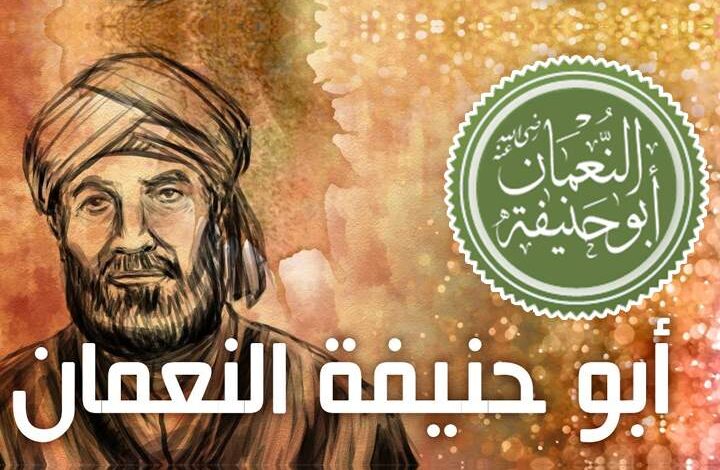
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، هو أحد الأعلام الخالدين في تاريخ الإسلام، وأحد الأئمة الأربعة الذين شكلوا أعمدة الفقه الإسلامي، وصاحب أول المذاهب الفقهية الكبرى. لم يكن أبو حنيفة مجرد عالم في الشريعة، بل كان عقلًا نادرًا، ومفكرًا مبدعًا، جمع بين عمق الفهم، ودقة الاستنباط، واستقلال الفكر، حتى صار مضرب المثل في الذكاء الفقهي، ورجاحة العقل، واستقامة المبدأ.
المولد والنشأة: في أحضان الكوفة
وُلد الإمام أبو حنيفة سنة 80هـ (699م) في مدينة الكوفة، في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. كانت الكوفة آنذاك من أهم مراكز العلم والفقه في الدولة الإسلامية، تميزت بثراءها العلمي وتعدد التيارات الفكرية فيها، مما أتاح لأبي حنيفة بيئة خصبة لصقل ملكاته.
ينتمي الإمام إلى أسرة فارسية الأصل، وكان والده “ثابت” من التجار المعروفين بالتقوى والورع. نشأ أبو حنيفة في بيت يحترم الدين ويُعلي من شأن العلم، فجمع منذ صغره بين التجارة والعلم، وهو ما ساعده لاحقًا على الاستقلال المادي والفكري، وحرره من التبعية لأي سلطة سياسية أو مالية.
بداية التحول إلى العلم الشرعي
كان الإمام في بداياته يشتغل بتجارة الخز (نوع من الأقمشة الفاخرة)، وقد برع فيها بفضل أمانته وذكائه، غير أن نقطة التحول جاءت عندما التقى بأحد العلماء الصالحين الذي قال له: “يا فتى، أراك فتىً ذكياً، فلم لا تلزم حلق العلم؟”. كانت تلك الكلمات كفيلة بتغيير مسار حياته.
بدأ أبو حنيفة بحضور حلقات العلم، ودرس الحديث، والفقه، وعلم الكلام، والنحو، وعلم الكلام، حتى استقر به المقام في الفقه. وتتلمذ على يد العالم الجليل حماد بن أبي سليمان، ومكث في صحبته قرابة ثماني عشرة سنة، لم يُفتِ خلالها بشيء دون إذن أستاذه، حتى توفي حماد، فخلفه أبو حنيفة في مجلسه.
سمات عبقرية أبي حنيفة
1. الذكاء الحاد وسرعة البديهة
أجمع المترجمون والمؤرخون على أن أبا حنيفة كان ذا ذكاء خارق. كان سريع الفهم، قوي الحجة، حاضر الجواب. ويُروى أنه جادل أحد الملحدين حول وجود الله، فسأله: ما دليلك على وجود خالق لهذا الكون؟ فأجابه الإمام: “رأيت سفينة مملوءة بالأمتعة تمخر البحر، تميل يمينًا ويسارًا، وتصل إلى شاطئها بسلام دون أن يقودها أحد”. قال الرجل: “هذا مستحيل”. فردّ الإمام: “إذا كان هذا مستحيلاً، فكيف ترى هذا الكون الهائل بنظامه الدقيق دون خالق يديره؟”.
2. إبداعه في القياس والاستنباط
كان أبو حنيفة أول من وسّع باب “القياس” في الفقه، إذ رأى أن النصوص محدودة، بينما الوقائع متجددة، ولذلك لا بد من الاستعانة بالعقل لفهم مقاصد الشريعة واستنباط الأحكام. وكان يقيس المسائل الجديدة على نظائرها في القرآن والسنة، مستخرجا الأحكام وفقًا للعلة المشتركة.
مثلاً، حين سُئل عن رجل حلف أن لا يأكل عنبًا فأكله عنبًا معصورًا (عصيرًا)، هل يحنث؟ فقال: “إنما حلف على العنب وهو لم يأكله كما هو، فلا يحنث”. دقة الاستنباط هنا تظهر كيف يزن الأمور بمنطق عقلي مرن يراعي نص اليمين ومقصده.
3. المنهجية الدقيقة في الفقه
لم يكن الإمام يُصدر الأحكام جزافًا، بل اتبع منهجًا علميًا صارمًا. كان يعرض المسألة على تلامذته في مجلسه، يناقشها معهم، ويرد على اعتراضاتهم، ثم يستقر على الرأي الذي يجده أقرب إلى الصواب. لذلك كان يُعد مجلسه بمثابة مدرسة علمية، سبقت في تنظيمها الجامعات الحديثة.
4. الاستقلال السياسي والعلمي
من أبرز علامات عبقريته أنه لم يُساوم على علمه. فعندما عرض عليه الخليفة الأموي يزيد بن عمر تولي القضاء رفض، وكرّر رفضه عندما طلب منه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ذلك، مع علمه بعواقب الرفض. فسُجن وعُذّب بسبب موقفه، لكنه صمد، وقال قولته الشهيرة: “لأن أُضرب بالسياط أحب إلي من أن أبيع ديني”.
تلاميذه ومشروعه العلمي
خرّج أبو حنيفة جيلًا من العلماء البارزين، أبرزهم:
- أبو يوسف القاضي: أول من تولى منصب قاضي القضاة في الإسلام.
- محمد بن الحسن الشيباني: فقيه ومؤلف بارز في المذهب الحنفي.
وقد نشر هذان العالمان فكر الإمام، وأسسَا لما يعرف اليوم بـ”المدرسة الحنفية”، التي امتدت في المشرق والمغرب، واعتمدها العباسيون ثم العثمانيون كمذهب رسمي للدولة.
أقوال العلماء فيه
- قال الإمام الشافعي: “الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة”.
- وقال الذهبي: “كان أبو حنيفة إمامًا، فقيهًا، زاهدًا، عالمًا، ربانيًا، صاحب عقل راجح”.
- وقال الإمام مالك: “كان رجلًا فقيهًا متقدمًا في العلم”.
مواقف خالدة تبرز رجاحة عقله
– في فهم المقاصد لا الظواهر
دخل عليه رجل وقال: “يا إمام، إذا نزعت ثيابي ودخلت الماء لأغتسل، أأستقبل القبلة؟” فرد الإمام قائلاً: “استقبل القبلة بقلبك”. إجابة تجمع بين الأدب الشرعي والفقه العملي، بعيدًا عن التكلف.
– في الفهم الدقيق للأحوال
سُئل مرة عن رجل ترك ماله عند صديقه ثم مات، هل يُضمن المال؟ فأجاب: “إن كان صاحب المال غنيًا، لم يُضمن، لأنه تركه اختيارًا، وإن كان فقيرًا، ضُمن، لأنه ربما كان أحرج في استرجاعه”. تحليل نفسي واجتماعي يُبرز بُعد نظره وذكاءه الفطري.
وفاته وإرثه الخالد
توفي الإمام أبو حنيفة سنة 150هـ في بغداد، وقيل إنه توفي مسمومًا في محبسه. صلى عليه آلاف الناس، حتى قيل إن الصلاة أُعيدت عليه ست مرات من كثرة الجمع.
ترك الإمام تراثًا فكريًا عظيمًا، وأسس مدرسة فكرية ما زالت تُدرّس إلى اليوم، وتؤثر في التشريع الإسلامي والأنظمة القانونية في عدد من الدول الإسلامية.
خاتمة: عبقرية عابرة للعصور
لم يكن أبو حنيفة مجرد فقيه، بل كان مفكرًا إسلاميًا شامخًا، سبق عصره في المنهج والتفكير، وفتح الباب لاجتهاد عقلاني، واعٍ، منضبط، لا يكتفي بالنصوص الجامدة، بل يبحث في مقاصدها، ويستوعب متغيرات الزمان والمكان.
إن دراسة سيرة هذا الإمام العظيم ليست فقط استعراضًا لماضٍ مشرق، بل هي دعوة لإحياء روح الاجتهاد، وتحفيز العقول على التفكير الحر المسؤول، كما فعل أبو حنيفة منذ أكثر من 1300 عام.