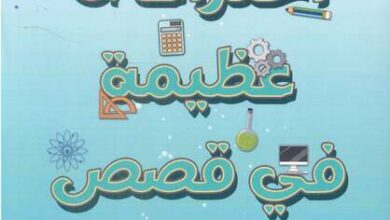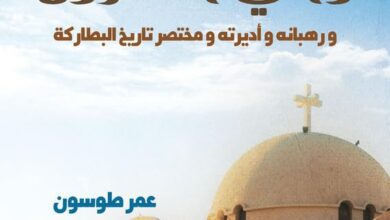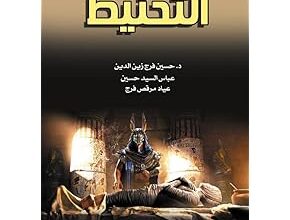الأدب المقارن في ضوء الرؤية العربية: قراءة تحليلية في كتاب يوسف بكّار
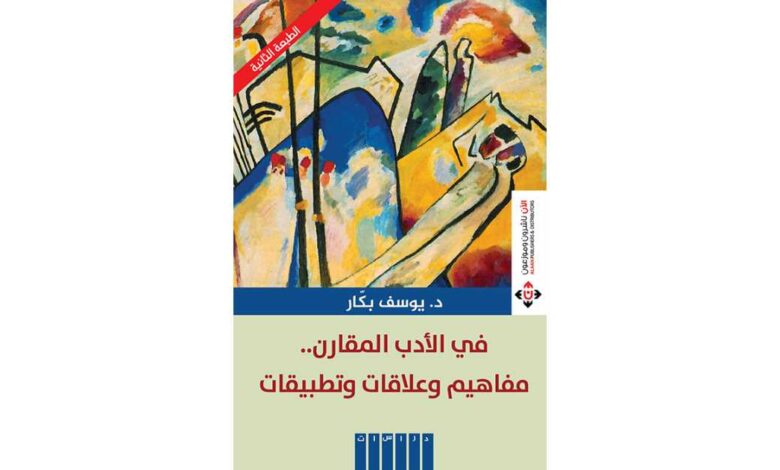
المقدّمة
يعدّ الأدب المقارن مجالاً معرفيّاً حيويّاً يجمع بين الدراسات الأدبية والتداخلات الثقافية والحضارية. وفي هذا الإطار، جاء كتاب “في الأدب المقارن : مفاهيم وعلاقات وتطبيقات” ليشكّل محاولة جادة من يوسف بكّار لتقديم رؤية شاملة ومنهجية عن هذا الحقل المعرفي، إذ يجمع بين المبادئ النظرية والتطبيقات العملية، مع إيلاء خاص للأدب العربي وعلاقته بآداب أخرى. وقد صدر هذا الكتاب عام 2023، عن “الآن ناشرون وموزّعون”.
تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه يُعنى بفتح الآفاق لفهم الأدب المقارن ليس باعتباره مجرد تقنية تحليل أو أسلوباً فرعياً، بل كمجال تربوي ونقدي وثقافي، قادر على استجلاء العلاقات بين النصوص واللغات والثقافات. وإنّ قراءة هذا الكتاب تضع القارئ أمام ثلاثة مستويات: المفاهيم (نظري)، العلاقات (تاريخي/حضاري)، والتطبيقات (تحليلي). ومن هذا المنطلق، سأستعرض في ما يلي محتوى الكتاب، ثم أعمل على تحليل نقدي لأبرز محاوره، وأختم بخلاصة وتوصيات.
عرض المحتوى والنظريات
1. تعريف الأدب المقارن ومفاهيمه الأساسية
في بداية الكتاب، يُعرّف المؤلف الأدب المقارن باعتباره «دراسة للكلمات والنصوص والأنساق الأدبية في العَلاقة مع غيرها من نصوص وآداب أخرى، مع التركيز على ظواهر التأثّر والتأثير، والاقتباس، والتثاقُف».
ومن المفاهيم التي يناقشها بكّار:
- التأثّر والتأثير: كيف تؤثر لغة أو أدباً ما في آخر، أو كيف يستلهم نص من نص آخر.
- التقليد والاقتباس: علاقة النص المحدث بالنص القديم، وعلى اختلاف أنواعها.
- التمثّل والتثاقف: أي كيف يستوعب نص ما ثقافة أو أسلوباً أجنبياً أو سياقاً غيره.
- الترجمة: باعتبارها جسراً ثقافياً وأدبياً يُسهّل التفاعل بين آداب متعددة.
- الاتصال الثقافي: تفاعل الحضارات من خلال الأدب.
ويُشير الكاتب إلى أن الأدب المقارن لا يقتصر على مجرد المقارنة الشكلية أو التقنية بين النصوص، وإنما ينطلق من وعي بالعلاقات بين اللغات والثقافات والأنظمة المعرفية.
2. المدارس والمنهجيات في الأدب المقارن
ينتقل بكّار بعد ذلك إلى عرض المدارس والمنهجيات التي اشتغل بها الباحثون في الأدب المقارن، والتي تضم:
- المدرسة الفرنسية: التي أسّست إلى مقاربات بين الآداب الأوروبية، وقد تأثر بها الأدب المقارن العربي.
- المدرسة الأمريكية: التي تميل إلى الجغرافيا الثقافية والدراسات العابرة للحدود.
- المدرسة السلافية: التي اهتمّت بدراسة الآداب في سياق تنقّل الشعوب والثقافات.
- ثم ينتقل إلى الرؤية العربية: ويتوقف عند إشكاليات الأدب المقارن في السياق العربي، مثل محدودية المصادر، وانتقائية التأثير الثقافي، وأهمية المعادلة بين المحلي والعالمي.
ويُفيد المؤلف بأن الأدب المقارن عند العرب لا يجب أن يكون استيراداً نقليّاً، بل محوراً نقدياً للكشف عن العلاقات الحقيقية بين الأدب العربي وغيره، مع المحافظة على الخصوصية والمقومات الذاتية.
3. العلاقات بين الأدب العربي والآداب الأخرى
يخصص بُعداً مهماً لبحث العلاقة بين الأدب العربي واللغات/الآداب الأخرى، لا سيّما الفارسية واليونانية والأوروبية. وبحسب الكتاب:
- الأدب العربي القديم تأثّر بالتراث الهندي (مثل «كليلة ودمنة») والفارسي، كما تأثر بالحضارة اليونانية والرومانية في العصور الوسطى.
- الأدب العربي في العصر الحديث اتّصل بالآداب الأوروبية الحديثة والثقافة الغربية، مما أدّى إلى تداخلات في الأشكال (شعر الحرّ، القصة القصيرة، المسرحية) وفي الموضوعات (الحداثة، الفرد، المدينة).
- كما يُدرج المؤلف تطبيقات محددة: على سبيل المثال، درس علاقة الشاعر عمر الخيّام والأدب العربي، أو تأثير الرباعيات الفارسية على الشعر العربي المعاصر، وهو ما يُظهر كيف يمكن للمنهج المقارن أن يفك شفرة التبادل الثقافي.
4. التطبيقات العملية والتحليل النصي
في الجزء الأخير تقريباً، يوفّر الكتاب دراسة تحليلية لتطبيقات المنهج المقارن على نصوص مختارة. فالمؤلف يقترح كيف يمكن للباحث أن:
- يختار نصاً من الأدب العربي، ثم يقارنه بنص من أدب آخر (فارسي، أوروبي، آسيوي) من حيث الموضوع، الأسلوب، البنية، الرمزية.
- يُراعي السياق الثقافي والتاريخي لكلا النصّين، إذ إن النص لا يتعلّق فقط بالكلمات، بل بالبيئة التي نُشِر فيها، واللغة، والمستقبل الاجتماعي.
- يستفيد من أدوات مثل: الترجمة، التثاقف، التناصّ (intertextuality)، التأويل، العلاقة بين النصّ والآخر.
- يستخلص نتائج: ماذا يكشف هذا التحليل عن النص العربي أو الأدب الآخر؟ كيف يُسهم ذلك في فهم التغيّر الأدبي أو التبادل الثقافي؟
ويُعطي مؤلّف الكتاب أمثلة تطبيقية، مما يجعل الكتاب ليس فقط مرجعاً نظريّاً، بل أداة فعلية للطلبة والباحثين.
تحليل نقدي
نقاط القوة
- شمول المنهج: إنّ التركيبة الثلاثية التي اختارها المؤلف (مفاهيم – علاقات – تطبيقات) تجعل الكتاب متماسكاً من حيث المنهج. وهذا يُسهّل على القارئ الانتقال من النظر إلى التطبيق.
- ربط الأدب العربي بغيره: في كثير من الدراسات العربية يُغفل الجانب المقارن ويكون الانشغال داخل الإطار العربي فقط. لكن يوسف بكّار يُقدّم هذا البُعد، مما يُثري الفكر الأدبي وينفتح على الثقافات.
- توسيع الأفق النقدي: من خلال إدراج الترجمة، التثاقف، التناصّ، السياقات الثقافية، يُشهد للكتاب بأنه لا يكتفي بالتحليل التقليدي، بل يتجاوز إلى ما هو مركّب ومعقّد في الأدب المعاصر.
- ملاءمة للدارسين والباحثين: الكتاب مفيد كمرجعية في الدراسات العليا، أو للطلبة المتخصّصين في الأدب المقارن أو النقد الأدبي، إذ يمنحهم أدوات واضحة ومنهجية.
بعض المآخذ أو نقاط النقد
- التركيز على أمثلة محدودة: ربما كان من المنهج الذي اتّبعه المؤلف أن يعطي أمثلة تحليلية أكثر تنوعاً جغرافياً (من آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية) وليس فقط التركيز على الفارسية/العربية والأدب الأوروبي. وهذا لو وُفّر لكان أضاف بعداً أوسع للكتاب.
- إشكالية المصادر: في المجال المقارن، تواجه الباحث العربي مشكلة المصادر والترجمات. إنّه ليس كل نص أو أدب مترجم بالكامل أو متوفّر بمعالجة نقدية. ربما كان الكاتب يستطيع معالجة هذا الإشكال بشكل أعمّ، من حيث استراتيجيات التعامل مع النصوص غير المترجمة أو المجهولة.
- عُمق التطبيق التحليلي: وإن بدا أن الكتاب يحتوي تطبيقات عملية، فقد يشعر بعض القرّاء بأن التحليل يحتاج إلى مزيد من التفصيل في كل حالة تطبيق، ربما مع مقارنات أكثر عمقاً بين النصوص، لا مجرد عرض قصير.
- لغة الكتاب وقابليته لعموم القُرّاء: باعتباره مرجعاً تخصصياً، قد يشعر القارئ غير المتخصّص أن اللغة الأكاديمية أو المصطلحات المكثفة قد تزيد من صعوبة المتابعة؛ ربما لو أُضيف ملخّص أو تبسيط لبعض الفصول لغير الأكاديميين.
التطبيقات والمآلات
من حيث البحث الأكاديمي
إنّ هذا الكتاب يشكّل قاعدة للدراسات المستقبلية في الأدب المقارن باللغة العربية. فالحديث عن الأدب المقارن بالطريقة التي تناولها بكّار يفتح الباب أمام:
- دراسات مقارنات بين الأدب العربي وآداب إفريقية أو آسيوية، بدلاً من التركيز التقليدي على الغربية أو الفارسية فقط.
- مشاريع ترجمة ونقد مشتركة، إذ إن الربط بين نصوص عربية وأخرى يتطلّب ترجمة دقيقة، وتحليلاً ثقافياً.
- تدريس مواد في الجامعات على أساس هذا المنهج: مثلاً مقرر «مقدمات في الأدب المقارن» أو «التثاقف الأدبي بين العربية والغرب».
- تمكين الطلبة من تحليل نصوصهم المحلية بمنهج مقارن، ليس فقط باعتبارها جزءاً من الأدب العربي، بل باعتبارها ظاهرة تتفاعل مع غيرها من الآداب والثقافات.
من حيث التأثير الثقافي والاجتماعي
حين يُنظر إلى الأدب المقارن كجسر بين الثقافات، فإن للكتاب تأثيراً يتجاوز الأوساط الأكاديمية إلى فضاء الثقافة الأوسع:
- في فهم القارئ أن الأدب ليس محصوراً داخل الحدود اللغوية أو الوطنية، بل هو فعل تواصل بين شعوب وحضارات.
- في تشجيع الترجمة والتبادل الثقافي. فالأدب العربي حين يُقارن مع غيره يُعبّر عن ديموميته وقدرته على الانفتاح.
- في إعادة الاعتبار للنصوص المحلية: فحين يُقارن النص العربي بنصّ آخر، يُمكن الكشف عن ما فيه من مبتكرات أو موروثات أو تأثيرات، مما يعزز الوعي الثقافي والذاتي.
- في مواجهة العزلة الثقافية أو الانغلاق، فالأدب المقارن يبيّن أن التفاعل ليس تهديداً للهوية بقدر ما هو تنمية لها.
آفاق مستقبلية
- يمكن للباحث العربي أن يأخذ من هذا الكتاب منطلقاً لبحث «الأدب المقارن الرقمي» أو «الأدب العالمي المقارن في ظل العولمة».
- يمكن إقامة حلقات دراسية أو ورش عمل في الجامعات بعنوان: “تطبيقات الأدب المقارن” بحيث يُطلب من الطلبة تطبيق المنهج على نصوص محلية أو عالمية.
- يمكن إصدار موسوعات أو مجلات متخصّصة في الأدب المقارن باللغة العربية، تستفيد من الأطروحات التي طرحها بكّار.
- يمكن تشجيع الترجمة إلى العربية لكتب مهمة في الأدب المقارن بلغات أخرى، مما يعزّز المكتبة المعرفية العربية في هذا الحقل.
خلاصة وتوصيات
أخيراً، يمكن القول إنّ كتاب “في الأدب المقارن : مفاهيم وعلاقات وتطبيقات” لمؤلفه يوسف بكّار يُعدّ إضافة قيمة للمكتبة العربية في مجال الأدب والنقد. ففي وقت يحتاج فيه الباحث العربي إلى مناهج تأصيلية ومترابطة لفهم النصوص في سياقاتها المتعددة، يأتي هذا الكتاب ليقدّم إطاراً منهجياً يُسهّل المهمة ويزيد من وعينا بأن الأدب ليس انعزالاً عن الثقافة أو الحقبة أو الآخر، بل هو دائماً تفاعل وانتقال.
التوصيات:
- أن يُدرج الكتاب ضمن مقرّرات الدراسات العليا في الأدب العربي والنقد المقارن.
- أن تُعدّ أوراق عمل أو دراسات تطبيقية بيُناءً على فصول الكتاب، بحيث يُطلب من الطلاب إجراء تحليل مقارن لنص عربي وآخر من خارج العربية.
- أن يُشجّع الباحثون ترجمة أعمال مشابهة أو تكملة هذا المنهج بتبويبات جديدة (مثل أدب ما بعد الحداثة، أدب الشتات، أدب اللغات الصغيرة) في سياق مقارن.
- أن يُنشأ منتدى أو ورقة دورية مستقلة تُعنى بـ«الأدب المقارن العربي» وتحتفي بالأبحاث التي تتناول علاقات الأدب العربي بالبنى الأدبية العالمية.
- أن يُقدّم إصدار مختصر أو ملخّص شعبي للكتاب لمن ليس لديهم خلفية نقدية تقليدية، وذلك لتوسيع دائرة الوعي بالأدب المقارن خارج الأوساط الأكاديمية.
في الختام، إنّ الاطّلاع على هذا الكتاب ليس مجرد قراءة لنظرية؛ بل هو خطوة نحو إعادة صياغة العلاقة بين النص والأدب والآخر والثقافة. وهو دعوة لكل قارئ عربي أو باحث أن «يفكّر بالمقارنة» كمنهج لا كخيار ثانوي.
لمعرفة المزيد: الأدب المقارن في ضوء الرؤية العربية: قراءة تحليلية في كتاب يوسف بكّار