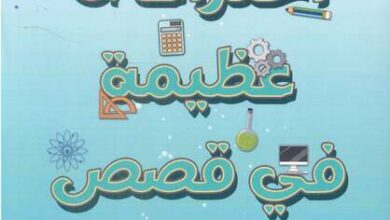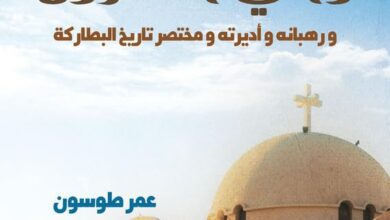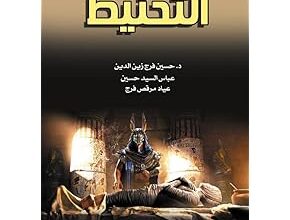القيادة الناجحة في ضوء القرآن الكريم: رؤية د. خير الدين الكوسوفي
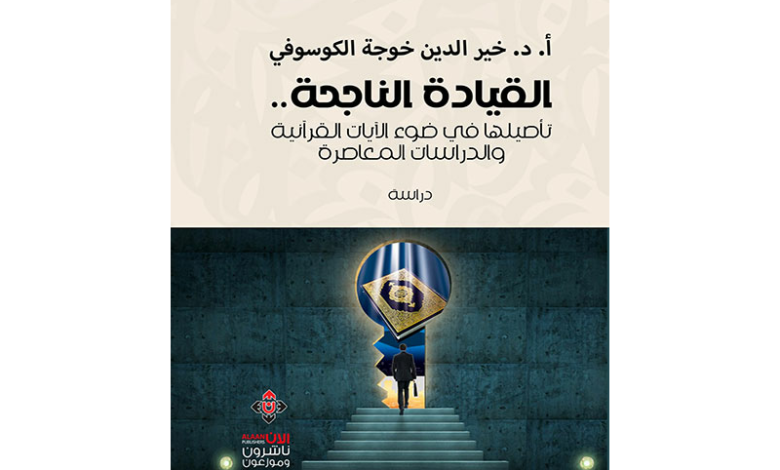
المقدّمة
في عصر تتسارع فيه التغيرات التنظيمية والاجتماعية والثقافية، وتظهر الحاجة إلى نماذج قيادية قادرة على التأثير الإيجابي وبناء الكفاءات، تبدو مسألة القيادة — سواء في المنظمات أو المجتمعات — من القضايا المفتاحية. ومن هذا المنطلق، يأتي كتاب «القيادة الناجحة: تأصيلها في ضوء الآيات القرآنية والدراسات المعاصرة» للمؤلف د. خير-الدين خوجة الكوسوفي (2023) كإضافة نوعية في ميدان القيادة، إذ يحاول ربْط الإطار القرآني بالبحث المعاصر في القيادة، وتقديم قراءة تأصيلية لنماذج القيادة الفعّالة.
في هذا المقال سنحاول استعراض محتوى هذا الكتاب من خلال:
- عرض لمحة عامة عن الكتاب (المؤلف، تاريخ النشر، التصنيف، الغرض)
- المنهج الذي اعتمده المؤلّف في الدراسة
- المضامين الرئيسة التي عالجها الكتاب
- تحليل لأهمّ المفاهيم القيادية التي يطرحها، وربطها بالآيات القرآنية والدراسات المعاصرة
- نقاط القوة والابتكار في الكتاب
- نقاط النقد أو الفرص التي قد يكون فيها تطوير مستقبلي
- تطبيقات واقعية مستخلَصة من الكتاب
- الخلاصة والتوصيات للقارئ المهتمّ بقيادة ناجحة.
1. لمحة عامة عن الكتاب
- عنوان الكتاب: «القيادة الناجحة: تأصيلها في ضوء الآيات القرآنية والدراسات المعاصرة».
- المؤلف: د. خير-الدين خوجة الكوسوفي، وهو أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، ومستشار أكاديمي في وزارة الدفاع القطرية، وأستاذ سابق في عدة كليات خارجية.
- تاريخ النشر: 2023
- عدد الصفحات تقريباً: 384 صفحة.
- الناشر: الآن ناشرون وموزعون (Alaan Publishing Co.).
- التصنيف: كتب عامة / فكر وتأصيل.
- الهدف العام: يسعى المؤلف إلى تأصيل علم القيادة الحديثة من خلال القرآن الكريم ومقارنته بالدراسات المعاصرة، ويعرض أن الدراسات الغربية في القيادة قد عجزت عن تقديم نماذج القيادة الشاملة أو القائد القدوة، بينما القرآن الكريم يقدم إطارًا ملموسًا للقيادة في مختلف مجالاتها.
- أهمية الكتاب تكمن في ربط القيادة المعاصرة بنصوص قرآنية وإبراز أن الإسلام قدّم مبادئ القيادة منذ عصر الأنبياء والرسل، مما يفتح إمكانية إعادة تأصيل النظرية القيادية في سياق إسلامي.
2. المنهج الذي اعتمده المؤلّف
يقدّم د. خوجة الكوسوفي في الكتاب منهجًا يجمع بين الوصف، والتحليل، والمقارنة النقدية. لقد بنى دراسته على الخطوات التالية تقريباً:
- استخراج مفاهيم القيادة من النصّ القرآني: من الآيات التي تشير إلى الخلافة، الإمامة، الولاية، القيادة الجماعية، الشورى، وغيرها.
- الوقوف على أنماط قيادية في السور والقصص القرآنية: مثل قيادة الأنبياء، والملوك الذين ورد ذكرهم، والمجتمعات التي أوكلت إليها مسؤولية.
- ربط هذه النماذج بمفاهيم القيادة المعاصرة: مثل القيادة التحويلية، القيادة التشاركية، القيادة الأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية التي تدرسها الدراسات الغربية.
- النقد المقارن: حيث يرى المؤلّف أن كثيرًا من الدراسات الغربية غطّت الجوانب الإدارية والتنظيمية فقط، ولم تبلغ إلى البُعد القيمي والروحي والشمولي الذي يقدّمه النصّ القرآني. ضمن هذا الإطار، يعرض المؤلّف «إشكالية القيادة الغربية» ويبيّن كيف يمكن للمنظور القرآني أن يعالج الفجوات أو يكمّلها.
- اقتراح إطار قيادي متكامل: يستلهم القيم القرآنية ويصوغ مؤشرات أو مبادئ يمكن أن تُوظّف في الواقع المؤسساتي أو المجتمعي.
3. المضامين الرئيسة للكتاب
من خلال قراءة لمحات ومراجعات الكتاب، تتبلور له عدة محاور رئيسة:
3.1 مفهوم القيادة في القرآن الكريم
يُعنى المؤلف بتحليل مصطلحات القيادة (الإمامة، الخلافة، الولاية، الملك، التمكين) في القرآن، وبحث كيف أن الإسلام عرض القيادة على أنها تكليف ومسؤولية وليس مجرد سلطة.
مثال على ذلك: مفهوم “الخلافة في الأرض” الذي يربط بين الإنسان وربّه وبين الإنسان ومجتمعه. وهذا يقود إلى أن القائد ليس مجرد مدير، بل وكيل على الجماعة أمام الله وأمام الناس.
3.2 أنماط القيادة الربانية والنبوية
يُعيد الكتاب بناء نماذج للقيادة من قصص الأنبياء والرُّسل: كيف تعاملوا مع جماعاتهم، كيف واجهوا التحديات، كيف أقاموا العدل، كيف استخدموا الشورى، وكيف كانوا قدوة في الأخلاق والسلوك.
ويشير المؤلّف إلى أن هذه الأنماط تمثّل “القيادة الكاملة” التي تشمل الأبعاد الروحية والأخلاقية والفكرية والعملية.
3.3 مقارنة مع الدراسات المعاصرة في القيادة
ثم ينتقل الكتاب إلى رصد ما توصلت إليه الأبحاث الغربية في القيادة: القيادة الاستراتيجية، القيادة التحويلية، القيادة التشاركية، القيادة الأخلاقية، القيادة الرقمية، وغيرها. ويُقيِّمها من منظور قرآني ويُبيّن مواطن التوافق والاختلاف.
من هنا، يعرض المؤلّف “إشكالية” الدراسات الغربية: أنها ربما ركّزت على الهيكل والتنظيم والأداء والمؤشرات، لكن أغفلت البُعد القيمي والروحي أو جعلته ثانويًا.
3.4 مبادئ أو مؤشرات القيادة الناجحة في ضوء القرآن والدراسات
يقدّم الكتاب مجموعة من المبادئ أو الأسس التي تؤدي إلى قيادة ناجحة، مستنبَطة من النص القرآني ومن بحوث القيادة الحديثة، مثل:
- العدل والمساواة بين المقودين
- الأمانة والصدق
- الشورى وعدم الاستبداد بالرأي
- العلم والخبرة
- المساءلة والمحاسبة
- الرحمة بالقادة والمقودين
- استعداد القائد لتحمّل المسؤولية والابتكار
- الاستشراف للمستقبل
- بناء الفريق والبطانة الصالحة
- أن القيادة ليست فقط لمن يتبوّأ سلطة، بل لكلّ من لديه قدرة وتأثير وإن اختلفت أدواره.
3.5 توصيات للتطبيق العملي
في نهاية الكتاب، يعرض المؤلّف توصيات لمن يرغب في ممارسة القيادة في المؤسسات أو المجتمعات: كيف يُوظّف القائد المبادئ القرآنية، كيف يصنع استراتيجيات قيادية، كيف يطوّر بيئة قيادية تشاركية وقيمية، وكيف يجمع بين الأبعاد المعاصرة (مثل التغير، التقنية، العالمية) والبعد الإسلامي الأصيل.
4. تحليل لأهم المفاهيم القيادية في الكتاب
سأُركّز هنا على بعض المفاهيم التي يطرحها الكتاب وسنبيّن كيف عالجها المؤلّف، مع أمثلة مختارة.
4.1 القيادة كتكليف وليس مجرد سلطة
من الملاحظ أن المؤلّف يؤكّد أن القيادة في القرآن ترتبط دائمًا بمفهوم المسؤولية أمام الله والناس، وليس مجرد ممارسة قوة أو إدارة موارد. فمثلاً في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَــعَلْنَـاكَ عَلَىٰ قَوْمٍ فَتَيَانًا﴾ (الفرقان: 20) نجد أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وُضع في موضع “فتى” أي قائد للمجموعة، تتحمّل تلك المجموعة أمامه أمام الله.
وبالتالي، القائد الناجح هو من نظر إلى مهمّته بوعي أنها خدمة، وإعمار، وإصلاح، لا مجرد إدارة وتوزيع وظائف. هذا يختلف عن بعض الدراسات التي ترى القيادة كـ “تنفيذ رؤيا استراتيجية” أو “تحفيز مرؤوسين” فقط.
4.2 الشورى والتشاركية
الكتاب يُبرز أن القرآن يؤكد مبدأ الشورى كأحد أُسس القيادة الفعّالة، ويُقال إن الشورى تقلّص من الاستبداد وتُعزّز المشاركة والثقة. من الآيات: ﴿وَأَجْرِهِمْ فِي الْمَشُورَةِ﴾ (آل عمران: 159) أو ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: 159) – (وقد وردت بصيغ مختلفة).
ومن منظور دراسات القيادة المعاصرة، هذا يتوازى مع مفهوم القيادة التشاركية والتحويلية التي ترى أن القائد ليس وحده يحمل القرار، بل يُشرك الفريق، يُمكّنه، يُطوّره، ويُولّيه. والمؤلّف يرى أن الشورى لم تكن مجرد هيئة مشورة، بل منهج جامع يربط بين القائد والفريق والمجتمع.
4.3 الأمانة والصدق والعدل
ثمة تركيز في الكتاب على أن القائد في القرآن يُذكَر مع صفة الأمانة والعدل: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
كما أن العدل يُعد من صفات القيادة الجديرة بالثقة. في الدراسات المعاصرة، تُعد الأخلاق القيادية “Ethical Leadership” من أبرز الاتجاهات، وقد تبيّن أن القائد الأخلاقي يؤدي إلى بيئة أداء أفضل وثقة أعلى بين العاملين. ما يفعله المؤلّف هو ربط هذا المفهوم بالأصالة القرآنية، وبيان أن القيادة لا يمكن أن تكون ناجحة دون أبعاد أخلاقية قوية.
4.4 الاستشراف والتخطيط والتغيير
الكتاب لا يكتفي بالجوانب الكلاسيكية للقيادة (قيم، أخلاق، شجاعة)، بل تتوافر فيه معالجة للبعد المعاصر: التغيير، التقنية، العولمة، تحديات التنظيمات، القيادَة في عصر المعرفة. إذ يرى المؤلّف أن القرآن قدّم مفاهيم قابلة للاستخدام في هذه السياقات المعاصرة، مثل مفهوم “البصيرة” أو “التمكين” أو “الخلافة” في الأرض، وكلّها تدلّ على أن القيادة تحتاج إلى رؤية فاعلة للمستقبل وليس فقط إدارة للحاضر.
4.5 القائد كقدوة
من أبرز ما يؤكّده الكتاب: أن القائد ليس مجرد مدبّر، بل نموذج يُحتذى به. وهذا التصور موجود في القرآن: يُذكر القائد مع الجماعة أو مع أتباعه، ويظهر تأثيره بحياته وأفعاله كما يظهر في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 110) بمعنى أن الأمة كانت مصدر نموذج وما يقوم به القائد يُرى ويتبع.
في الدراسات المعاصرة، يُشير مفهوم القيادة التحويلية إلى أن القائد يُلهم ويُطوّر ويمثّل بصمة أخلاقية وسلوكية. والمؤلف يُبيّن أن هذا المبدأ كان موجودًا في النصّ القرآني قبل أن يُدرَس أكاديميًا.
5. نقاط القوة والابتكار في الكتاب
- الجمع بين التأصيل القرآني والنظرية الحديثة في القيادة: كثير من الكتب تُعنى بالقيادة من الناحية الإدارية فقط أو من الناحية الدينية فقط، لكن هذا الكتاب يربط بين النصّ القرآني والبُعد المعاصر.
- تحليل نقدي للدراسات الغربية وإظهار مواطن القصور: المؤلف يقدّم رؤية ناقدة تسعى إلى تمكين الباحثين والممارسين من رؤية القيادة من منظار إسلامي أصيل.
- تقديم إطار منهجي واضح: استخدام منهج وصفي – تحليلي – مقارن يتماشى مع البحث الأكاديمي، مما يجعل الكتاب مقبولًا للدارسين والباحثين.
- استفادة عملية: ليس مقصورًا على النظرية فقط، بل يتضمّن توصيات وتطبيقات يمكن للقائد والمؤسسة أن يستقي منها.
- سهولة لغة المؤلّف في تناول موضوع مركّب: رغم الأبعاد الفلسفية والفكرية، فإن المؤلف يسعى إلى أن يكون قريبًا من الممارس.
6. نقاط النقد أو فرص التطوير
- رغم قيمة الكتاب، إلا أن أي عمل بهذا الحجم لا يمكن أن يغطي كل جوانب القيادة المعاصرة (مثل القيادة الرقمية، القيادة في ظل الأزمات، القيادة الافتراضية) بعمق كافٍ، وبالتالي قد تكون هناك حاجة لإصدارات لاحقة تعمّق هذه الجوانب.
- الدراسة ربما تركز على الجانب الإسلامي والقرآني أكثر، ويكون من المفيد دمج المزيد من دراسات حالة ميدانية وتطبيقات حقيقية من منظمات معاصرة، خاصة في العالم الإسلامي أو المختلط.
- قابلية الترجمة أو التكيف الدولي: بما أن المنظور قرآني وإسلامي، فقد يواجه بعض القُرّاء غير المسلمين أو في سياقات علمانية صعوبة في التبني الكامل، لذا يمكن إصدار نسخة مخصصة لهذا الجمهور مع تعديلات لغوية ومنهجية.
- تضمين أدوات قياس وتقييم: من المفيد أن يتضمّن الكتاب في الطبعة المقبلة أدوات قياس (مثل استبيانات، مؤشرات) يمكن للممارس استخدامها لتقييم القيادة داخل مؤسسته.
7. تطبيقات واقعية مستخلَصة من الكتاب
إلى القادة أو من يرغبون في ممارسة القيادة الناجحة، يمكن استخلاص عدد من التطبيقات من مضامين الكتاب:
- تأسيس رؤية قيادية وقيم واضحة: على القائد أن يبدأ بتحديد الغاية (العُمرانيّة والروحية) وليس فقط الربحية أو النمو. هذه الرؤية تستلهم من مفهوم «الخلافة في الأرض» أو «الإمامة» كما ورد في القرآن، وبالتالي تجعل القائد في موقع خدمة ومسؤولية.
- تعزيز الشورى والمشاركة: في المؤسسة يمكن للقائد أن يُفعّل هيئات استشارية، ويُشرك الفريق في اتخاذ القرار، ويُطوّر ثقافة النقاش والمحبة بين القائد والفريق، ما يعزّز الالتزام والابتكار.
- بناء أخلاق القيادة: الالتزام بالأمانة، الصدق، العدل، الوفاء بالعهود، والرغبة في الإصلاح. هذه الأخلاق تُترجَم في ممارسات: شفافية القرار، عدالة التوزيع، الاهتمام بالمرؤوسين، احترام الكفاءات.
- التمكين والتطوير المستمر: كما في النصّ القرآني «وَلْيَتَفَكَّرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ» (الطور: 8) أو ما يماثلها؛ يترجم ذلك في أن القائد يعلي قيمة التعلم، يأخذ بخبرة الفريق، يُعلّم وينمّي، ويُتهيّأ للتغير والتحديث.
- المساءلة والمحاسبة: لا تتجاهل القيادة الناجحة أن القائد مسؤول أمام الله وأمام الناس، يجب أن يكون هناك آليات للمراجعة والتقييم، مثل مؤشرات الأداء، التغذية الراجعة، ثقافة “التعلّم من الخطأ”.
- الانفتاح على الواقع المعاصر: بالرغم من أن المرجع القرآني حاضر، لكن القيادة اليوم تواجه تحديات مثل التغيّر التكنولوجي، العولمة، العمل عن بُعد، وجائحة كورونا. لذا على القائد أن يُوظّف المبادئ القرآنية في سياق حديث: “كيف نتحكّم في الواقع بدل أن يكون الواقع يتحكّم بنا”.
مثال تطبيقي: في مؤسسة تعليمية في مصر (أو مصر) يستطيع المدير – كقائد – أن يُركّز على “الشورى” من خلال تشكيل مجلس طلابي أو هيئة استشارية للمعلمين، ينظر في قضايا التطوير والابتكار، ويُعطيهم مساحة التصرف، ما يعزّز الانتماء ويُطوّر القدرة القيادية لدى الطلاب والمعلمين معا.
8. الخلاصة والتوصيات للقارئ المهتمّ
يُعدّ كتاب «القيادة الناجحة: تأصيلها في ضوء الآيات القرآنية والدراسات المعاصرة» عملاً مهمًّا يسدّ فراغًا في أدبيات القيادة الإسلامية والعربية، إذ ليس كثيرًا ما نجد دراسة شاملة تربط بين النصّ القرآني وفلسفة القيادة المعاصرة بصيغة مقارنة وتأصيلية.
من بين أبرز توصيات للقارئ:
- اقرأ الكتاب بتركيز، ودوّن المبادئ التي تنطبق على وضعك المهني أو المؤسسي.
- جرّب تطبيق إحدى المبادئ (مثل الشورى، أو بناء القيم، أو التمكين) في فريق عملك، وقيّم النتيجة.
- شارك مع زملائك أو فريقك مناقشة حول “ما معنى أن أكون قائدًا ناجحًا في ضوء النص القرآني ووقتنا المعاصر؟”
- إذا كنت طالبًا أو باحثًا، فكر في عمل بحث تطبيقي يناقش كيف تمّ تطبيق بعض هذه المبادئ في مؤسسة عربية – إسلامية، وما كانت النتائج، واستفد من أدوات القياس.
- أن يُعدّ الإصدار المقبل من الكتاب أن يتضمّن دراسات حالة تطبيقية، أو إصدار جدول استبانات جاهز، أو ترجمة إلى لغات أجنبية، أو إصدار خاص للشركات والمؤسسات.
في الختام، إن القيادة ليست مجرد خطاب تنظيمي أو إدارة موارد، بل هي رسالة وأمانة ومسؤولية. وعندما نُدرك أن النصّ القرآني قد قدّم لنا في قصص الأنبياء والملوك نماذج قابلة للاقتداء، وأن المفاهيم المعاصرة في القيادة يمكن أن تستفيد من هذا التراث، فإننا نستطيع بناء قيادة ناجحة، قيَمية، مستدامة، ومُؤثرة.
من هذا المنطلق، يُشكّل كتاب د. خوجة الكوسوفي مرجعًا يُضفي عمقًا فكريًا ومنهجًا عمليًا لمن يسعى لأن يكون قائدًا ناجحًا بامتياز.
لمعرفة المزيد: القيادة الناجحة في ضوء القرآن الكريم: رؤية د. خير الدين الكوسوفي