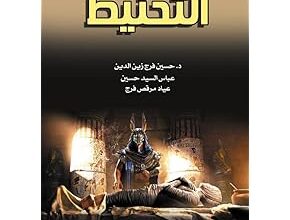مراجعة كتاب الهشاشة النفسية لإسماعيل عرفة

إسماعيل عرفة هو صيدلي وباحث في الإلحاد. صدر له كتاب “لماذا نحن هنا؟”، وله عدد من المقالات والمشاركات الفعالة في التوعية الإيمانية للشباب.
يأخذنا كتاب الهشاشة النفسية في رحلة نحتاج لخوضها، عبر ثمانية فصول ومائتي صفحة؛ يمر بنا بين عدّة ظواهر قريبة منا، وبعض مفاهيم وثقافات عالمنا المعاصر، التي نجحت في لمسنا -أو تكاد-؛ ليفتح أعيننا بأسلوب سهل وشيّق على مكامن الهشاشة النفسية فيها، ويقدّم لنا في كل فصل بعض النصائح والحلول لعلاجها، مستفيدًا في ذلك بشكل واسع من جهود المتخصصين الغربيين، لذا فإن كتاب الهشاشة النفسية يزخر بأسماء شخصيات وكتب قيّمة، وهذا أحد وجوه الفائدة فيه.
تنبيهات قبل عرض الموضوع
قدّم لنا الكاتب عدّة تنبيهات مهمة قبل قراءة كتابه الهشاشة النفسية، وهي:
أن ظاهرة الهشاشة النفسية سابقة الحضور، وأوسع انتشارًا، وأحظى اهتمامًا في العالم الغربي. أما في العالم العربي، فقد بدأت ملامحها بالظهور منذ عام 2017 -برأي الكاتب-. كما تقتصر على جيل المراهقين والشباب من الطبقات العليا والوسطى التي تُشكّل أقل من 40%.
أن الكتاب ليس أكاديميًا، بل هو اجتهاد يهدف لإثارة الجدل حول الظاهرة والاهتمام بها وعلاجها.
أن الكتاب لا يرفض الآلام أو يهوِّنها، بل يسعى لإحداث توازن.
أن الكتاب ليس موجهًا لأصحاب الأمراض النفسية الحقيقة.
مدخل: جيل رقائق الثلج
توصف “الهشاشة النفسية” بأنها حالة من الضعف النفسي التي يضخم فيها الفرد مشاكله وآلامه لتصبح في عينه أكبر من قدرة تحمّله، وتتمثَّل في وصف المشكلات بأوصاف أكبر من حجمها قد تصل إلى وصفها بكارثة وجودية! والسلوك غير الناضج في الحياة، وعدم تحمّل المسؤولية، والانكسار من أبسط مشكلة أو كلمة. وقد يصل الأمر إلى رفض النضج أساسًا، في حالة تُعرف باسم متلازمة بيتر بان.
أدى ذلك إلى تأخر متوسط سن المراهقة -كما أكدت عديد من الدراسات- إلى سن الخامسة والعشرين، وحفز ذلك الباحثين والمحللين الغربيين على تسمية جيل المراهقين والشباب بجيل رقائق الثلج. وللتسمية سببانِ، أولهما: سرعة انكسارها. ثانيهما: اختلافها وتفردها في الهيكل فيما بينها. وجيل رقائق الثلج هو الجيل سريع التكسر المُغذَّى بأفكار التميز والريادة والاستحقاق الذاتية خلال التنشئة.
فللإنسان مرونة نفسية منذ صغره تمكنه من التكيف مع المؤثرات الخارجية حسب استجابته، وهذا النمط من التربية يحرم الفرد اكتساب المناعة، وتطوير ميكانيزماته النفسية من خلال تحمل المسؤولية والتعرض للمصاعب. ومن هذا المنطلق، فإن علاج الهشاشة النفسية يكون بإعادة بناء الصلابة النفسية والثقة في النفس، من خلال تدريب النفس على حمل المسؤوليات ومواجهة الصعاب وحل المشكلات تدريجيًا، وطاعة الأمر الإلهي بالتقوى ومخالفة الهوى؛ إذ فيهما أصل القوة ومغالبة النفس.
هوس الطب النفسي
يتمثّل هذا الهوس في اتجاه متصاعد لإحالة أحزاننا ومشكلاتنا الحياتية الطبيعية إلى أمراض تحتاج العلاج الطبي. وأحد أهم أسبابه الانسلاخ من الدين ونسيان الآخرة، وتكريس الاهتمام بالدنيا، ما يحث سعينا وراء سبل الوصول لأقصى درجة من السعادة والصحة النفسية ورفض ما يكدرها.
كما أن لأيديولوجيا الصحة النفسية اليوم دورًا مهماً؛ إذ تعتبر راحة البال والسعادة مؤشرًا للسواء النفسي. تكمن المشكلة هنا في المحددات غير الواقعية؛ فالحزن جزء حتمي لا تكتمل حياة الإنسان بدونه. يقول فرانسيس آلان (أحد محرري المرجع الأول للاضطرابات النفسية): “إن السواء النفسي (ما هو طبيعي) والاضطراب النفسي مفهومان سائلان غير منتظمان، مختلفان باستمرار، ولا حدود فاصلة ثابتة بينهما”.
ولعل السبب الأغرب لهذا الهوس هو أزمة السيولة والتضخم في التشخيص وصرف الأدوية، ومن تمثلات هذه الأزمة ما يتعلق باضطراب ما بعد الصدمة، إذ كان يُشخّص قبل عام 2000 -حسب النسخة الثالثة للمرجع الأول للاضطرابات النفسية (1980)- بمعايير أكثر وضوحًا وموضوعية، فالمريض يمر بتجربة شديدة الهول من الحزن تتجاوز الخبرة البشرية العادية، مشروطةً بالمرور بظروف استثنائية كالتعذيب، والحروب، والاغتصاب، أمّا بعد عام 2000 -حسب نفس المرجع- صارت أية تجربة تسبب أذى ماديًا أو نفسيًا -وإن كانت كلمة-، مع آثار مستدامة على الصحة الذهنية والنفسية والاجتماعية والروحية والمادية، وبذلك يصبح المعيار ذاتيًا يحدده المريض.
هذا الأسلوب في التشخيص زاد من تعقيده، فاضطراب ما بعد الصدمة -كما يقول “آلان فرانسيس” -، يسهل كتابته على الورق، لكن من شبه المستحيل اكتشافه في الحياة الواقعية، لأنه يعتمد على تشخيص الطبيب القائم على تقرير المريض لحالته، وذلك يصعّب تقدير الاضطراب بدقّة.
ومنها أيضًا اضطراب الاكتئاب الحاد. يُشخّص الاكتئاب الحاد على المستوى النظري بإرهاق، ونقص الشهية، واضطراب النوم، والإحباط وفقدان الاهتمام. مشروطةً بالاستمرار لأكثر من أسبوعين. هذه المعايير -كما يصف آلان فرانسيس- لا أساس موضوعيًا لها، ولا مبرر منطقيًا لحَديّتها، ولا تعني حتمًا أن الشخص مكتئب، وليست إلا آراءً اعتباطية لأطبّاء نفسيين.
إن حياة الإنسان مصممة أساسًا لتتضمن الأحزان، مثل الطلاق أو الموت أو الضغط بشكل طبيعي، لذا فإنها -وإن كانت تسبب هزة نفسية قوية- لا تعني من حيث الأصل مرضنا. وللأسباب الآنف ذكرها، توسّعت مصطلحات الاضطراب النفسي والاكتئاب والصدمة، لتشمل غير المرضي حقيقةً، وإنما مجرد محزونين بأحزان طبيعية، ما خلق اعتقادًا عند العوام بوجوب زيارة الطبيب النفسي عند المرور بالأحزان الطبيعية.
تحوّلت الآن الاضطرابات النفسية بالفعل إلى موضة. ولوسائل الإعلام دور بارز في ذلك. بالإضافة إلى شركات الأدوية -التي تعمل بمبدأ الولاء الذاتي- وأساليبها التسويقية، وعدم نزاهة بعض الأطباء النفسيين، وفي هذا يقول “آلان فرانسيس”: “أكثر من 54% من محرري الدليل الرابع كانوا على اتفاق مع أصحاب الشركات”. كل ذلك ساهم أيضًا في تضخيم التشخيص الخاطئ.
ونتيجة لذلك، لم تعد الأدوية أمرًا مقتصرًا على المرضى الذين يحتاجون إعادة تأسيس لعمل أنظمة الاتزان الداخلية التي تساعد على التعافي مع الوقت من الحزن. بل سُوّغت للطبيعيين ممن يُعتقَد أنهم مرضى! وبدلًا من مواجهة أحزانهم أو انتظار زوال مشاعرهم السلبية، مستعينين بما يخفف عنهم، مثل الرياضة أو البوح؛ فإنهم يتناولون الأدوية التي تتداخل مع تلك الأنظمة فتُعطّلها وتُضعِف المناعة النفسية.
الفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي؟
ينشأ الفراغ العاطفي من عدم إشباع الحاجة الفطرية لوجود شخص يقاسمنا الحب ونسكن إليه. ويتغذى بتأخر سن الزواج، وغياب التنشئة العاطفية السليمة داخل الأسرة، وهشاشة العلاقات الإنسانية؛ هذه العوامل إضافة إلى أخرى أسهمت في انتشار الفراغ العاطفي في العالم العربي.
عندما تشتد الرغبة لملأ هذا الفراغ، تضعف النفوس أمام أية وسيلة لملئها. ومن تمثلات ذلك الرضا بالعلاقات السامة. وظاهرة “الكراش” التي تكشف عن سلوك عاطفي غير ناضج، مشحون بمخزون عاطفي، ورغبة قوية في الحب، تُفرّغ بشكل شبه عشوائي أو متسرّع.
يُغذَّى الفراغ العاطفي على أمور أخرى: ضعف تقدير المرء لنفسه، الذي يجعله باحثًا عن الإطراء والإعجاب؛ العزلة التي تحرم الإنسان من الحصول على العطاء العاطفي الذي يحتاج إليه عبر دوائر الدعم من الأصدقاء، وفراغ الوقت والذهن، فالفراغ يوسع المجال لكثرة التفكير في المشكلة، وكثيرًا ما يُملأ بما يفسد ويعمق المشكلة، مثل الأفلام والمسلسلات، وأخيرًا الفراغ الروحي، فعدم وجود صلة بين المرء وربه تترك فراغًا في الروح لا يمتلئ بغيره.
من الفراغ العاطفي إلى الفراغ الوجودي
يعتري الإنسانَ شعورٌ بالفراغ الوجودي عندما ينسى أو يجهل معنى الحياة وغايتها، وتعززه الحاجة الفطرية للخضوع لله.
وفي سياق حضاري مادي عدمي، يغيب فيه دور الدين الرئيس في الإجابة عن الأسئلة الوجودية، صار الكثير من الشباب إلى الشعور بالاغتراب، والقلق والحزن. إن الفراغ الوجودي يشل قدرتنا على احتمال مآسي الحياة. أو قد يدفعنا إلى اللامبالاة في مراقبة حياتنا، والشره في البحث عن المتع في محاولة بائسة لإشباع هذه الحاجة.
السوشيال ميديا: أصل الشرور
لا مجال للإنكار أن لوسائل التواصل الاجتماعية (السوشيال ميديا) جانبًا مشرقًا، لكن يجب كذلك أن ندرك بشكل جيّد جانبها المظلم.
جرعة النرجسية
تشعل السوشيال ميديا الحاجة الفطرية في الإنسان لنيل الإعجاب والتقدير إلى حد مبالَغ، وربما جنوني. فالسوشيال ميديا تمثل قوقعة يدور فيها الإنسان حول فلك نفسه، ويميل البعض لاعتبار الآخرين جمهورهم الشخصي الذي يبثون إليه من طرف واحد، إنّها توفر مساحة واسعة للتعبير عن النفس بطرق مختلفة، لا لفائدة؛ بل لمجرد التعبير الذاتي، من أبرزها الصور ذاتية الالتقاط “السِّلْفِي” وما يتصّل بها من الغرور والتركيز على الذات. هذا يجعلنا نلهث وراء الإعجاب والتفاعل الإيجابي، وعلى قدره تتحدد هويتنا. كما يجعلنا شديدي الحساسية تجاه النقد، عند نيل التفاعل الإيجابي يُحفَّز نظام المكافأة في الدماغ إلى مستوى قد يصل إلى مكافأة الغذاء والجنس. وهذا يفسر صيرورتنا إلى الإدمان الذي يجعلنا في حالة نفسية سلبية، عندما لا نحظى بالإعجاب.
التغيير من أجل التغيير
في سياق ثقافي يتجه نحو رفض التقيد بتقليد معين والاكتفاء بالحالي، والهوس بالتطور والتغيير والسرعة؛ تأتي السوشيال ميديا -باعتبارها عالمًا متجددًا من الأحداث المثيرة والمتسارعة- لتعزز قيمة التغيير، لا لشيء سوى التغيير نفسه، إن العيش في عالم يقدس التغيير يجعل أفكارنا سريعة التطاير غير يقينية، ويزيد من سرعة شعورنا بالملل، ويغذي شعورنا بالاستحقاق، ما يجعلنا عرضة للإحباطات المتكررة؛ بسبب توقعاتنا المرتفعة، كما يظهر أثره جليًا على جيل المراهقين الذي يتوقع نجاحًا سريعًا وفوريًا.
ضاع تركيزنا
وباعتبارها عالمًا مثيرًا ومتغيرًا، فإنها تشد انتباهنا بقوة، ثم تشتته بين الأحداث المتسارعة، وتشل قدرتنا على التركيز العميق طويل المدى. ومن أهم ما نفقده هو مساحات التأمّل والمراجعة الذاتية، أو تشويشها بجعلنا نركز على إنجازات الآخرين. إن كثيرًا من أسباب الهشاشة والحزن والاكتئاب هو بسبب فقد هذه المساحة.
وهم معايير النجاح
مع تداخل الحياتين -الافتراضية والواقعية- تشوَّشت معايير النجاح في حياتنا؛ لتصبح الأعداد المرتفعة من التفاعلات الإيجابية والشعبية حاكمًا لها، وإن كان المحتوى تافهًا. وقد نفقد شعورنا بقيمة إنجازاتنا الحقيقية، إذا لم تحظَ بالقدر الكافي منها. كما تركز انتباهنا على إنجازات الآخرين وتلمعها؛ فتخلق الرغبة في تحقيق ما يحققه الغير -وإن كان غير مناسب لنا-. تكمن المشكلة أيضًا في غياب تفاصيل الوصول إلى تلك الإنجازات، وفتح باب واسع لادعاء الاجتهاد الفردي المحض. يعزز ذلك من زرع مفهوم “العمل الجاد = النجاح الحتمي”. وهو مفهوم خطير غير واقعي، يجعلنا شديدي الحساسية من الفشل، وعرضة لجلد الذات والاكتئاب والإحباط وغيره.
أفكار من ورق
الأفكار الورقية هي تلك التي تتحور وتتكيّف حسب المصلحة. يتَّجه الكثيرون على السوشيال ميديا لصناعة أفكار من ورق، إما حفاظًا على شعبيتهم، أو خوفًا من الحظر أو التشهير، وإما اتفاقًا مع معيار نجاحي ينص على أنك يجب أن تكون محبوباً من الجميع.
هذا السلوك يورث البلادة والميوعة، ويورث الحساسية الشديدة تجاه النقد، ويعطّل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يتطور مع الوقت إلى العجز عن اتخاد مواقف في أعماقنا، واختيار مشاعر صادقة.
لا تحكم على الآخرين
أدى هوس الثقافة الغالبة بقيم التسامح وتقبل الآخر، والحرية الشخصية، لشيوع عقلية اللاحكم بين المراهقين والشباب؛ إذ يرفضون تمامًا الحكم أخلاقيًا على الأشخاص والأفعال والسلوكيّات، فضلًا عن النطق به أو إسداء النصح.
تعارض هذه العقلية مكوّنًا فطريًا أساسيًا. فالإنسان بصفته كائنًا عاقلًا أخلاقيًا؛ يطلق الأحكام على كل شيء بموجب الفطرة، وبدونه يُعطّل ضميره، ويموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما تحمل في طياتها اتّهام الأحكام بالسطحية والنسبية، فتجعلها كلها متساوية، وبالتالي فلا شيء له أهمية.
إن المشكلة لا تكمن في الحكم أساسًا، بل فيما كان منه غير منضبط بالأسس السليمة والطريقة والغرض الصحيحَيْن. عندما يصح الحكم، فإنه يساعدنا على تحسين أنفسنا. هذه الثقافة من اللاحكم صنعت للشباب والفتيات مساحات آمنة من الانتقاد وتحمل مسؤولية تصرفاتهم؛ ما جعلهم شديدي الحساسية لأي كلمة أو حكم سلبي.
مشاعرك الداخلية: أسوأ حكم في حياتك؟
إنّ ما يلمس مشاعر الناس هو الأقدر على تحريكها. نجح هذا المبدأ في عوالم السياسة والاجتماع والإدارة والاقتصاد والسينما، حيث تم استعمال مشاعرنا كأدوات. وأصبحت ثقافتنا المعاصرة تعظم من قدر المشاعر بشكل غير مسبوق، أصبحنا نتعرض بشكل مبالَغ للإثارة الشعورية. وفي زمن الآلات والثقافة الاستهلاكية، أصبح ما يحرك شعورنا هي أمور اصطناعية تمدنا بالإثارة الفورية. ما جعلنا نفقد القدرة على اعتناق المشاعر طويلة الأمد.
في هذا السياق، صارت المشاعر مركز اهتمام الإنسان المعاصر؛ لكونها تحقق نموذج الحياة الكاملة القائم على عبادة النفس، وتستمد جاذبيتها بكونها مفتاح الانفتاح الشخصي. ومن تمثلات ذلك الشره وراء ما يثير الأحاسيس القوية التي لا يكتفي منها؛ فإذا تعلّق الأمر بالعمل، فإنه سيبحث عن الشغف وحسب، كما يتصوّر الزواج بشعور واحد: الحب بصورته الرومانسية الخيالية. ولا يفرّق بين الانفعالات اللحظية كالانبهار والإثارة والشهوة (أو كما يسمى الكراش)، وبين الحب الحقيقي طويل الأمد، الذي يبنى شيئا فشيئا بعد معرفة حقيقة بمميزات الشخص وعيوبه.
مخدرات الشغف
نجح المؤثرون والمتحدثون الملهمون -كما يُسمّون- في بث رسالة “اتبع الشغف” عبر أساليبهم المليئة بوعود السعادة والنجاح، وخطاباتهم التحفيزية العاطفية. تقوم هذه الفكرة على تحقيق الشغف معيارًا للسّعادة والنجاح، والعمل الجاد طريقًا للوصول الحتمي، وإن لم تحقق شغفك، فالمَلُوم الوحيد هو أنت. وتكمن المشكلة في هذا الخطاب أنّه يعمل كمخدر وهمي يرسم حياة سعيدة متفائلة مغيِّبًا حقائق ومؤثّرات الواقع، أو مقللًا شأنها. فالشغف قد لا يؤَمِّن أُولى الأمور: لقمة العيش، وقد لا يوافق القدرات والمهارات. كما أنّ مشاكل الواقع في نواحيه المختلفة قد تكون -بديهيًا- سبب الفشل لا التقصير في العمل، والحظ المحض قد يكون سبب النجاح. وفقط عند تجاوز هذه المشكلات، يكون اتباع الشغف أمرًا محمودًا.
يبدأ تلامذة هؤلاء بالركض خلف شغفهم بروح مندفعة تعانق السماء. ثم تأتي الردّة عنيفة بعد أن يصطدموا بمصاعب الواقع ومشاكله، أو أن شغفهم لا يناسبهم أساسًا، مع ما يتكبدونه من خسائر مادية ومعنوية؛ فيتسبب ذلك في دخولهم في حزن عميق وخيبة وجلد للذات، وفقدانهم الثقة بأنفسهم وفي أهليتهم لإقامة حياة.
مفتاح النجاة: أنا مريض نفسي إذًا أنا أفعل ما أريد
نحن هنا مع تيار ثقافي يقدس الحالة النفسية، فيعطيها الهيمنة على العقل، ويجعلها المحرك الرئيس لكل الأفعال، وبذلك تصبح عذرًا مقبولًا لأي جرم كان (يشمل هذا الإلحاد لأسباب نفسية لا عقلية)، بل مَدعاةً للتعاطف مع الأشرار.
وتكمن المشكلة هنا في الاستخدام الفضفاض لمصطلح الاضطراب النفسي دون تحري الدقة، كما جعْل كل الاضطرابات النفسية مُوجِبًا لسقوط المسؤولية.
وأخيرًا، إن الإسلام يشترط العقل والفهم والأهلية للتكليف، والبحث الدقيق لإثبات امتناعها قبل رفعه. ومتى فعلنا نجد امتناعها استثناءً لا أصلًا. إنه يجعلنا مسؤولين عن أفعالنا حتى في أشد حالات البؤس كالانتحار، ويربينا على تحمل المسؤولية والصبر والاحتساب.
المصدر: موقع تبيان