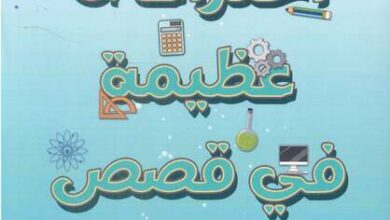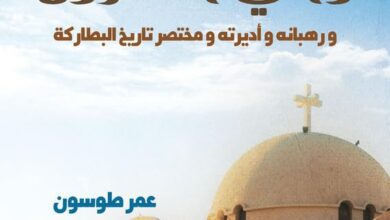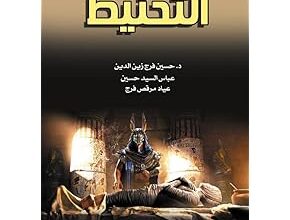مسيرة مجد وعبقرية: حياة جاك كيلبي مخترع الدارة المتكاملة وصانع ثورة الإلكترونيات الحديثة
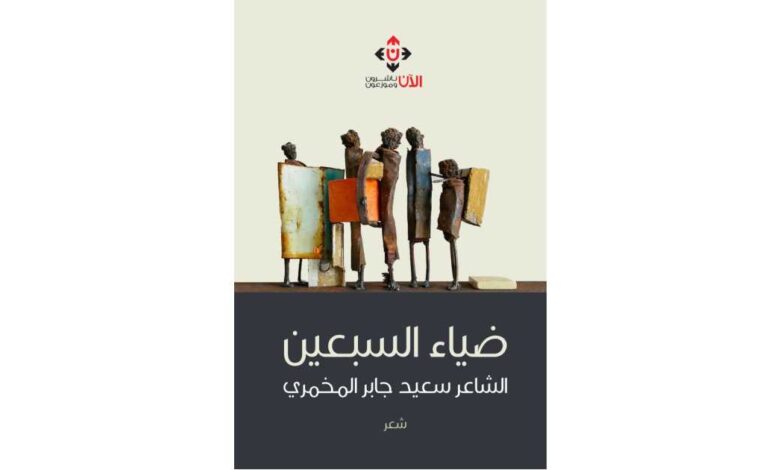
المقدّمة: السياق الأدبي والثقافي للكتاب
حين يصدر ديوان جديد، خاصة في حقبة تتسم بالتغيّر الاجتماعي والثقافي، يصبح من الضروري أن ننظر إليه ليس كنص منعزل، بل كنتاج تلاقت فيه الرؤية الفردية مع المحيط الثقافي والشعري. ديوان “ضياء السبعين” للشاعر العُماني سعيد جابر المخمري هو مثل هذا النص الذي يحاول أن يجمع بين عدة أبعاد: الوطنية والدينية والإنسانية، وبين الأصالة والحداثة، وبين المحلي والعالمي.
صدر الديوان في عام 2023 (أو حسب بعض المصادر في نهاية 2022) عن دار الآن ناشرون وموزعون. يبلغ عدد صفحاته ما بين 232 و304 صفحة حسب الطبعة.
ويُصنّف الديوان عادة ضمن دواوين الشعر الفصيح أو الأدب والشعر.
اسم الديوان، “ضياء السبعين”، يفتح أكثر من باب للتأويل: ما معنى “الضياء” في الشعر؟ وما علاقة الرقم سبعين بهذا الضياء؟ قد يشير الرقم إلى مرحلة عمرية، إلى رمز ذاتي أو روحي، أو إلى بعد ثقافي أو تاريخي، أو قد يكون رمزيًا يرتبط بثيمة النص (سأعود إلى هذا لاحقًا).
في هذا المقال سننتقل من السياق العام إلى تحليل المكونات الأساسية للنص: الموضوع، البنية، الأسلوب، اللغة والصور، ثم سنستعرض نقاط القوة، التحديات التي قد تواجه الديوان، وأهمية هذا العمل في المشهد الشعري العُماني والعربي.
عرض عام للديوان ومحدداته
قبل الدخول في التحليل، من المفيد أن نقدم عرضًا عامًا لما يتيحه الديوان من معلومات وتوجهات:
1. الشخصية الشعرية للشاعر
سعيد جابر المخمري هو شاعر من ولاية شناص بسلطنة عمان، وله حضور ملحوظ في المشهد الشعري المحلي. من خلال تصريحات النبذة عن الديوان، يُعرض أن للمخمري بصمة واضحة في الساحة الشعرية العُمانية، وأنه من البارزين قبل النّهضة المعلنة وما بعدها. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن الشاعر مارس موضوعات متعددة: الوطن، الدين، الغزل، القضايا الاجتماعية.
وُصف أيضًا بأنه شاعر يمتلك رؤية حالمة تمزج الواقع بالخيال.
هذه السمات تضع توقعًا بأن الديوان سيحاول أن يجمع بين النبرة الذاتية والانفتاح المجتمعي، بين التأمل الفردي والهم الوطني، وربما بين الإشارات التراثية والمحاكاة الحداثية.
2. المضمون العام والتوجهات المحورية
من النبذة المتاحة، نعلم أن الشاعر تفرّع في أساليب الشعر وفنونه، واكتسب واقعية ومخيلة، واستخدم مفردات شعبية وتراثية، جال بها في وصف محافظات عمان ومناطق خارجها. يُبرز أن الشاعر لم يقف عند الشعر الوطني فقط، بل كتب أيضًا في الغزل والدين والقضايا الاجتماعية.
كما تُشير النبذة إلى أن مشاركاته في الفعاليات المحلية والخارجية ساهمت في صقل تجربته الشعرية.
إذًا، يمكن القول إن الديوان يحمل طفرات متعددة: الوطن، الدين، الحب، الإنسان، وربما قضايا الهوية والانتماء.
3. البناء والهيكل العام (ما يمكن استنتاجه)
ليس من المتاح أمامي النص الكامل للديوان، لكن من خلال اطلاعي على بعض المعاينات في “معاينة” Google Books وبعض المقتطفات، يمكن ملاحظة أن النص ليس ديوانًا منظمًا وفق تقسيمات واضحة مثل “وحدة وطنية، وحدة غزل، وحدة دينية” (أو إذا وُجد هذا التقسيم، فإنه غير معلن صراحة في المصادر المتوفرة).
كما أن بعض المقتطفات التي تظهر في المعاينة تحمل مفردات دينية صريحة مثل “الله”، “روح”، “دين”.
بما أن الديوان مؤلف من عدة قصائد، يمكننا أن نفترض أن الشاعر استخدم الانتقال بين الموضوعات لتفادي الرتابة، وربما استعمل التمهيد أو القصائد التمهيدية والختامية لإضفاء وحدة تكوينية داخلية.
التحليل التفصيلي للنصوف الشعريّة (الموضوع، الأسلوب، اللغة)
في هذا القسم سنحاول تتبّع الخطوط الكبرى في المضمون، ثم ندخل في الأسلوب واللغة والصور، مع عرض أمثلة من نصوص متاحة (من المعاينات) وتحليلها.
1. الموضوع والهموم المركزية
أ. الوطن والانتماء
الوطن يبدو من الموضوعات المركزية في الديوان. من النبذة يُذكر أن الشاعر كتب قصائد وطنية، وقد جال في نصوصه على محافظات السلطنة ومناطق كثيرة. الشعر الوطني هنا لا يقتصر على المدح أو الدفاع فحسب وإنما أيضًا التعبير عن الولاء، الحنين، التشبث بالمكان، ربما النقد البناء أو الدعوة إلى الإصلاح.
هذا التوجه يضع الديوان في سياق تجارب شعرية معاصرة تحاول أن توازن بين الفخر والمساءلة، بين الاحتفاء بالهوية والإشارة إلى التحديات التي تواجه الوطن.
ب. الدين والروحانيات
من المعاينات التي رأيتها، تتكرر كلمات مثل “الله”، “الروح”، “الدين”. المعروف أن الشعر العربي المعاصر لا ينأى عن البعد الديني، لكنه يقترب منه أحيانًا بصيغة تأملية أو بلاغية أو أسلوبية (لا بالضرورة تعليمية أو وعظية). في “ضياء السبعين” يبدو أن الشاعر لا يخشى توظيف المفردة الدينية كجزء من بناء الصورة الشعورية، وربما كمُناجاة أو كوسيط روحي بين الذات والعالم.
ج. الحب والغزل
تُذكر في نبذة الكتاب أن الشاعر كتب الشعر الغزلي. في الشعر العربي، الغزل يشكّل فراغًا تشكيليًا هامًا، فهو يسمح للشاعر بأن يغادر القضايا الكبرى ويدخل في المناطق العاطفية الدقيقة، ويظهر قدرته على تحريك المشاعر. قد يستخدم المخمري الغزل كمنفذ فردي، أو كتعزيز لصورة الإنسان الذي يتوق إلى القرب، إلى الحبيب، إلى الجمال.
د. الإنسان والقضايا الاجتماعية
إذا تأمّلنا في عبارة أن المخمري يغرد بصوته وألحانه “بالقصائد الاجتماعية” أيضًا، نجد أنه يؤشر إلى أن الديوان يتضمن قصائد تعكس هموم الناس، وتناقش مشاكل الحياة اليومية، أو على الأقل تلامس الإنسان في محنه وأفراحه.
القضايا قد تكون في الفقر، الهجرة، البطالة، العزلة، أو الظلم، أو في البُنى المجتمعية التي تحتاج إلى نقد أو تفكير. لا يمكن تأكيد ذلك إلا من خلال قراءة النص الكامل، لكن النيّة مضمّنة في النبذة التي يقدّمها الناشر.
هـ. الخيال والتأمل
كون الشاعر يُوصف بأنه “حالم” ويُمزج فيه الواقع بالخيال، فإن الخيال والانفتاح التأملي هما عنصر مهم في بناء النص الشعري. فربما في بعض القصائد نجد مناجاة أو تأملاً في الكون أو الوجود، أو تصويرًا رمزيًّا للعالم كمرآة للنفس.
2. الأسلوب الشعري واللغة
أ. اللغة بين الفصحى والعامية
من الملاحظ أن النبذة تقول إن الشاعر يحمل في مخيلته كمًّا كبيرًا من المفردات الشعبية والتراثية. هذا لا يعني بالضرورة أن النص شعري بالمحادثة العامية، لكنه يشير إلى أنه لا يتجنّب منبع اللغة العامية أو الشعبية في بعض المفردات أو الصور، ربما في التعبير عن الأحاسيس المباشرة أو في الأوصاف الأرضية.
استخدام مفردات من البيئة المحلية يقوّي الانتماء ويقرب النص من القارئ المحلي، من دون أن يفقد أناقته الفصحوية. قد يكون المزج بين الفصحى واللمسات الشعبية وسيلة للتوسّط بين التوثيق الشعري والعفوية التعبيرية.
ب. الصور البلاغية والتشبيهات
لا يمكن أن نتحدث عن ديوان شعري من دون أن ننتبه إلى الصور البلاغية: التشبيه، الاستعارة، الكناية، التماثل، والترصيع البلاغي. في المعاينة التي تقدّمها Google Books، نرى مفردات مثل “الروح”، “الشوق”، “القلب”، “النور”، ما يدل على أن الشاعر يستثمر رموزًا كونية ومعنوية للتعبير عن الذات والعلاقة بالعالم.
الشاعر قد يستخدم التشبيه الرمزي لتقريب المعنى العاطفي: كأن يُشبّه الحب بالنور، أو القلب بالمنارة، أو الوطن بالنفس. هكذا الرموز تنفتح على دوافع التأويل وتضفي أفقًا رحبًا للنص.
ج. الإيقاع والوزن
لا تتوفر في المصادر التي اطلعتُ عليها النسخة الكاملة التي تكشف عن الأوزان الشعرية المستخدمة، لكن من طبيعة الشعر العربي المعاصر أن الشاعر قد يتراوح بين الالتزام بالأوزان التقليدية (كالبسيط، الكامل، الطويل، وغيرها) وبين الشعر الحر أو التفعيلات. قد يستخدم المخمري هذه المراوحة ليُعبّر عن التنوع في الموضوعات: مثلاً القصائد الوطنية قد تتطلب وزناً ثقيلاً ورنانًا، أما القصائد التأملية أو الغزلية فقد تستريح إلى وزن أخف أو أكثر حرية.
د. العنوان “ضياء السبعين” كلقب شعري
كما ذكرت في المقدّمة، العنوان بحد ذاته يحمل دلالات. كلمة “ضياء” تحمل معنى الإشراق، النور، البصيرة، والوضوح. الرقم “السبعين” قد يرتبط بمرحلة عمرية، أو برمزية العدد سبعين في الثقافة العربية (مرحلة النضوج، أو بعد تجربة طويلة، أو رقم مقدّر). يمكن أن يُقرأ العنوان على أنه إعلان عن ضياء نابع من تجربة ناضجة بعد مرور الزمن، أو إشراق الروح بعد رحلة.
من الممكن أن كل قصيدة تمثل بُعدًا من أبعاد هذا الضياء، أو أن العنوان يعكس وحدة روحية تجمع القصائد تحت شعاع هذا الضياء، كما لو أن الشاعر بعد سنوات من التجربة أضاء شيئًا في الذات أو في العالم.
أمثلة تحليلية من نصوص المعاينة
فيما يلي تحليل مختار لمقتطف من المعاينة التي توفرها Google Books:
“آه أبيات إذا البيت الحق الخير الدار الدنيا الدين الذي الروح السير الشعر الشوق الشيخ الفرح القلب الكرم الكل الله اللي …”
هذا المقتطف يحمل تراصًّا للمفردات، كما لو أنها استحضار لمفردات كونية يجري ترتيبها في بنية شبه موسيقية. يمكن ملاحظة:
- المفردات تحمل دلالات كبيرة: “البيت”، “الحق”، “الخير”، “الدين”، “الروح”، “الشوق”، “الفرح”، “القلب”، “الكرم”، “الله”. الكثير منها مفردات مطلقة، تحمل تحتها سماء واسعة من التأويل.
- التراص اللفظي: الشاعر يضع المفردات جنبًا إلى جنب، كما لو أنه يعكس روافد حياته، أو يعبّر عن تمازج القيم.
- انعدام الروابط النحوية الظاهرة: النص في هذا المقتطف قريب من التعداد الشعري أو العشيقة، أي أنه يعتمد على تجميع المفردات التي يتماهى بعضها مع بعض بالمعنى أو بالرنين الصوتي.
- هذا الأسلوب قد يشير إلى رغبة الشاعر في الإضاءة على المفردة بوحدتها، لا في التأطير النحوي أو الربط الشكلي.
مثل هذا الأسلوب يعكس تأثرًا بشعر الحداثة أو ما يُعرف بالشعر المكثّف، الذي يتجنب الحشو ويعتمد على كثافة المفردة ودلالتها. كما أنه يفتح النص على قراءة تأملية للناظر في المفردة، وكأن الشاعر يدعونا لإعادة ترتيب هذه المفردات في ذاكرتنا الخاصة.
نقاط القوة في الديوان
من خلال ما عُرض وتحليل المعطيات المتوافرة، يمكن تحديد عدة نقاط قوة في ديوان “ضياء السبعين”:
- الطموح التنوعي
أن يشمل الديوان الوطني والديني والغزلي والاجتماعي في آن واحد هو أمر طموح، ويُظهر يقظة الشاعر إلى أن الإنسان متعدد الأبعاد، ولا يمكن حصره في قالب واحد. - المزج بين الأصالة والحداثة
استخدام مفردات تراثية وشعبية مع لغة فصحوية تأملية يُعد ميزة جميلة، لأنها تربط القارئ المحلي بالتراث، بينما تحفظ النص بُعده الشعري الفخم. - الرمزية والانفتاح التأملي
العنوان، والتكديس اللفظي في المقتطف أعلاه، تفتح النص على مستويات متعددة من التأويل، بحيث لا يُقرّر المعنى النهائي للقارئ بل تُعوّضه تأملات متعددة. - الهوية والانتماء
أن الشاعر يتناول محافظات عمان والمناطق المختلفة يدل على أن النص ليس منعزلًا عن المكان. هذا النوع من الشعر يعزّز الانتماء الثقافي ويقوي الجسور بين القارئ والنص. - الجرأة في استخدام اللغة
التراص اللفظي والتداخل بين المعاني (كما في المقتطف أعلاه) يُظهر أن الشاعر ليس خائفًا من المخاطرة اللغوية، وأنه يحاول ترك أثر لحضور لغوي قوي.
التحديات أو الملاحظات النقدية المحتملة
لكل ديوان، خصوصًا الطموح، تحديات ومجالات للتحسين. إليك بعض الملاحظات التي قد تؤخذ في الاعتبار:
- غياب وسهولة في الربط البنائي
إذا اعتمد الشاعر كثيرًا على التجميع المفردي والتراص دون الربط النحوي أو الانتقال المنطقي بين المفردات، قد يشعر القارئ أحيانًا بالتفكّك أو الضياع في النص. بناء القصائد وترتيبها في الديوان قد يحتاج إلى سياقات انتقالية أو قصائد تمهيدية وخاتمية تربط الأجزاء ببعضها. - الإفراط الرمزي أو التجريد
حين يزدحم النص بالمفردات المطلقة أو الرمزية دون سياق قصصي أو سردي، قد يصبح بعض النصوص صعبة الفهم للقارئ العادي أو البعيد عن المشهد الشعري المعاصر. - اختيار الوزن والإيقاع
إن اتّجه الشاعر إلى التجديد التام أو التحرّر الكامل، فقد يواجه مسألة الوعاء الإيقاعي (ما الذي يعزّز الإيقاع في النص؟)؛ وإن التزم كثيرًا بالأوزان التقليدية فقد يُشتكى عليه بالتزامية أو رتابة، إذا لم يكن هناك تغيير مدروس. - الموازنة بين الموضوعات
من الصعب على ديوان واحد أن يكوّن توازنًا مثاليًا بين موضوعات شتى (الوطن، الدين، الحب، القضايا الاجتماعية). قد يطغى على الديوان موضوع معين، ويُترك الآخر في الكواليس. القارئ قد يتوقّع توازنًا أو تناسقًا في التوزيع الموضوعي. - الوضوح مقابل الغموض
الشعر الجميل هو الذي يفتح النص على تأويلات متعددة، لكن إذا ذهبت التجربة نحو الغموض المفرط قد يُفقد القارئ قدرته على الالتقاط. على الشاعر أن يحافظ على توازن بين الجمالية الغامضة والقطعة التي تراعي القارئ.
أهمية الديوان في المشهد الشعري العُماني والعربي
من منظور ثقافي وأدبي، “ضياء السبعين” قد يحمل أهمية بارزة لعدة أسباب:
- إثراء المشهد الشعري العُماني
يقدم تجربة شعرية حديثة في سلطنة عمان، تسهم في تنويع الإنتاج الشعري المحلي. وجود ديوان مترف الطموح كهذا يضع علامة جديدة في خريطة الإبداع العُماني. - تمثيل جزء من الهوية العُمانية
الشاعر، من خلال وصفه للمناطق العُمانية واستخدامه المفردات المحلية، يُسهم في حفظ الذاكرة الشعرية للسلطنة، ويقارن بين ما هو محلي وما هو عامّ. هذا الربط بين المحلي والعام يُعدّ جسرًا مهمًا. - فتح أفق التجريب الشعري
بتوظيفه للتراص المفردي واللغة المكثفة والتداخل بين الموضوعات، يُقدّم المخمري تجربة قد تلهم شعراء آخرين في السلطنة والمنطقة. التجريب ضروري لتجديد الحالة الشعرية، وهذا الديوان ربما يُعتبَر محاولة إبداعية من هذا النوع. - المحاكاة الإقليمية
الشعر العربي المعاصر يشهد تجارب متعددة في الخليج والعالم العربي؛ وجود ديوان كهذا في عمان يُساعد على أن تكون التجربة العُمانية جزءًا من الحوارات الأدبية العربية، ويجذب اهتمام النقّاد والقرّاء في العالم العربي. - تجربة في المزج بين الأبعاد
كون الديوان يحاول المسير في أبعاد متعدّدة (وطن، دين، غزل، إنسان) هو بحد ذاته تجربة ثقافية، تُظهر أن الشاعر المعاصر ليس مضطرًا للاحتكام إلى بعد واحد فقط، بل بإمكانه أن يكون شاملًا ومتعدد الطبقات.
مقترحات لتناول الديوان بقراءة نقدية أعمق
إذا أردت أن تُعنى بدراسة “ضياء السبعين” في مقالة أو بحث أكاديمي، فإليك بعض المقترحات:
- دراسة مقارنة مع دواوين عمانية أخرى
كيف يقف ديوان المخمري إلى جانب دواوين معاصرة في عمان؟ ما الفوارق في الرؤية أو الأسلوب؟ ذلك يُظهر خصوصية النص. - تحليل نصي تفصيلي لقصائد مختارة
اختر ثلاث إلى خمس قصائد تمثيلية من الديوان، وقرئها من حيث البناء الداخلي والتكرار والصورة والمعنى، ثم استخرج ما يميزها. - قراءة بينية تأثرية
حاول أن تبحث عن المصادر التي قد تأثر بها الشاعر (من التراث العربي أو المحلي أو التجارب الشعرية المعاصرة) لتبيّن أين يلتقي النص مع ما قبله وأين يختلف عنه. - دراسة الجمهور والتلقي
كيف يقف القارئ العُماني أو العربي تجاه مثل هذا النص؟ هل يُقرأ بسهولة؟ هل يتطلب تأويلاً مخصصًا؟ كيف تُستقبل رمزية العنوان والمفردات؟ - اللغة والتشكل الشعري
تحليل التكنيك الشعري: الوزن، الإيقاع، التقطيع، الفواصل، التكرار، التماثل، التراص المفردي. كيف يُوظّف الشاعر هذه الأدوات، وما أثرها في انسياب النص؟ - البعد الزمني والرقمي
اقتران إصدار الديوان في عقد ثالث من القرن الحادي والعشرين. كيف يتفاعل مع التغيرات الاجتماعية والإعلامية في العصر الرقمي؟ هل يُوظّف الشاعر عناصر الحداثة (التكنولوجيا، العولمة، التواصل) أو يُحاول أن يئنّس النص أمام التحديات المعاصرة؟
الخاتمة
ديوان “ضياء السبعين” لسعيد جابر المخمري هو تجربة شعرية تستحق الوقوف عندها بتمعّن. إنه يجمع بين الوطن والدين والإنسان، بين الأصالة والتجريب، بين الضياء والرقم، وبين اللغة المكثفة والخيال التأملي. على الرغم من أن النص الكامل لم يكن متاحًا لي بالكامل، فإن ما استطعت الاطلاع عليه يكشف عن شاعر واعٍ يسعى إلى أن يدشّن نصًا شعريًا يحمل أبعادًا متعددة له صداها في النفس والوجدان.
لمعرفة المزيد: مسيرة مجد وعبقرية: حياة جاك كيلبي مخترع الدارة المتكاملة وصانع ثورة الإلكترونيات الحديثة